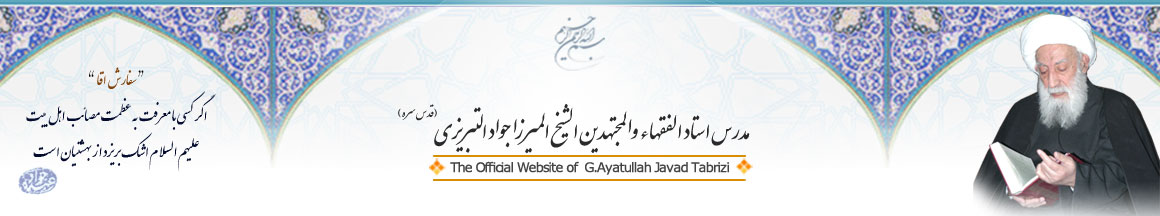الإصلاح بين الناس
لا يكفي في الإسلام أن يكون المسلم مستقيماً في حياته الفردية متجنباً الأضرار بالناس، بل المطلوب منه والخير له أن ينتقل سعيه الذاتي إلى الإصلاح بين الناس الذين يعيش معهم. ذلك أن الإصلاح بين الناس من أهداف المسلمين المؤمنين، لأن المؤمن مرآة أخيه، يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها. فعلى المؤمنين شرعاً أن يسعوا للإصلاح كيما يتفاقم الشر ويتطور النزاع، فمن عداوة بين شخصين إلى عداوة بين قبيلتين، وربما يتحوّل إلى سفك دماء، وكثيراً ما يحصل أن تقسم الأمة إلى جماعات لا همّ لهم سوى الثأر والنكاية والإضرار.
والإصلاح بين الناس لا يصدر إلا من قلوب نبيلة ونفوس تحب الناس كافة وتسعى من أجلهم وتعمل لخيرهم. من هنا يأت في الخير والنفع للمجتمع، ومن هنا تتوثق الروابط الاجتماعية بين الناس وحدة متعاونة على البر والتقوى. لذلك أمر الله المؤمنين بالسعي للإصلاح بين إخوانهم. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾.
كما دعاهم عزّ وجلّ للقيام بالإصلاح بين المؤمنين في حال النزاع.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ…﴾.
والرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله قال: (الخلق كلهم عيال الله، واقربهم إليه أنفعهم لعياله) فبقدر ما نفيد عيال الله، بقدر مانحسن إليهم ونصلح بينهم ونقترب من مرضاته تعالى أكثر.
والإمام الكاظم عليه السلام حثّ أصحابه على الإصلاح بين الناس كما شجّعهم على الإحسان لمن أساء إليهم، وبيّن لهم عاقبة المحسنين والمصلحين وما لهم من الأجر عند الله. فقال عليه السلام: (ينادي مناد يوم القيامة ألا من كان له أجر على الله فليقم، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح).
حسن الجوار
من أخلاق الإسلام العظيمة حفظ الجوار فهو من الفضائل التي دعا إليها الله في كتابه العزيز، وهو نعمة من نعمه لأن الجار إذا كان صادقاً في قوله وأميناً في معاملته، وحافظاً حقوق جاره يكون الجار الآخر في أمن وأمان واطمئنان منه، إذ أنه يحفظه حاضراً وغائباً.
والجار الأمين صديق لجاره وأنيس له، يساعده في حاجاته، ويعوده في مرضه ويخفف عنه أثناء شدته يقول المثل السائر: اسأل عن الجار قبل الدار، وعن الرفيق قبل الطريق. وقال بعضهم: إذا بعت داري فلا أبيع جاري.
وروي عن لقمان أنه قال لابنه:
واعــــــــــرف لجــــــارك حــــــقــــــه والحـــــــــــق يـــــــعــــرفـــــه الكــريم
فمن أين لنا في هذه الأيام الجار الكريم الذي يعرف واجبه تجاه جاره؟!! الحياة الإنسانية حياة اجتماع وسعادة، والوحدة بين الشر أمر طبيعي دعت إليها الحاجة الحياتية. من هنا قال علماء الاجتماع: الإنسان مدني بالطبع. لأن الإنسان بطبيعته وطبعه اجتماعي ألوف ولا خير في امرئ لا يألف ولا يؤلف. قال عزّ وجلّ في التآزر والتكاتف: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا..﴾ وقال الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله: (الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق، الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الجوار، وحق الإسلام، وحق الرحم. وأما الذي له حقان: فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك).
وعن الإمام زين العابدين عليه السلام: (وأما حق جارك، فحفظه غائباً، وإكرامه شاهداً، ونصرته إذا كان مظلوماً، ولا تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوء سترته عليه، وإن علمت أنه قبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، ولا تسلمه عند شديدة، وتقيل عثرته، وتغفر ذنبه، وتعاشره معاشرة كريمة، ولا قوة إلا بالله).
والإمام الكاظم عليه السلام أوصى أصحابه بالإحسان إلى الجار والصبر على تحمّل الأذى والمكروه منه قال عليه السلام: (ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى) اللّهم اعطنا القدرة على تحمّل أذى جيراننا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت السميع العليم.
إغاثة المستجير
في التعاليم الإسلامية الهامة التي دعت إليها الرسالة النبوية وأوجبت على المسلمين العمل على تطبيقها إغاثة المستجير، أو الملهوف، وهي دعامة متينة من دعائم البناء الاجتماعي في الإسلام. وقد أرسل الله تبارك وتعالى النبيين ليرشدوا الناس إلى النور، إلى الصراط المستقيم، ولو أهمل تطبيق الشريعة الإسلامية لاستشرى الانحلال الأخلاقي في المجتمع البشري، وبذلك يكون إغاثة الملهوف من أوجب الواجبات التي تترتب على الفرد في المجتمع الإسلامي المصون، وبصورة خاصة في أيامنا هذه حيث أصبحنا في عصر استولت على قلوب البشر المداهنة والمداراة، ونسوا أن تناسوا الخالق الذي أمرهم بالمحبة والأخوة، فاسترسلوا في اتباع أهوائهم وأنانيتهم بلا حدود، فعمّت الفتن، وشاعت الجهالة وضاعت الفضائل الأخلاقية حتى أصبحت تصرخ وتستغيث: أنقذوني! أنقذوني! من براثن الأنانية. لذلك: أوجد الله وجود جماعة من أولي الحل والعقد يمثلون الأمة ويراقبون سياستها وسير أعمالها. هذه الجماعة قصدها الله سبحانه بقوله: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.
هذه المسؤولية لا تقع على عاتق هؤلاء الجماعة فقط، بل من واجب كل مؤمن ومؤمنة التصدي للظلم، والدعوة إلى الخير، ومساعدة إخوانه المحتاجين، فهم إن لم يكونوا إخوة لنا في الدين فهم أسوة في الخلق.
والإمام الكاظم عليه السلام: حث أصحابه على إغاثة المستجير، وقضاء حاجة المحتاجين فقال: (من قصد رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله فلم يجره ويقدر عليه فقد قطع ولاية الله عزّ وجلّ).
وقد أمرهم بقضاء حاجة الناس فقال عليه السلام: (من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه، فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا، وهو موصول بولاية الله، وإن ردّه على حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله عليه شجاعاً ينهشه في قبره إلى يوم القيامة).
وقال عليه السلام في فضل من يقضي حاجة أخيه المؤمن: (إن لله عباداً في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة، ومن أدخل على مؤمن سروراً فرح الله قلبه يوم القيامة).
التراحم والتعاطف
حث الإسلام على التزاور بين المسلمين، لأن ذلك يوطد أواصر المحبة فيما بينهم ويطلعهم على حاجات بعضهم البعض.
والمحبّة التي يبغيها الإسلام للمؤمنين هي المحبّة الخالصة لوجه الله، تلك التي تدفع صاحبها على الدوام إلى محبّة الجميل في أي إنسان تمثل، وإلى تفضيل الجليل من أي مكان صدر هذه المحبّة الناتجة عن التزاور والتعاطف تدوم وتستمر لأنها لوجه الله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.
والمرء لا ينال هذا اللون من المحبّة على وجهها السليم إلا بمثل هذا العون الربّاني. من هنا كان القول: إن من علامات رضى الله على الإنسان المؤمن محبة الناس له، ومن علامات غضب الله على الإنسان كره الناس له وتفرّقهم من حوله. قال تعالى لنبيه موسى عليه السلام: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾.
وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: (الخلق كلهم عباد الله وأقربهم إليه أنفعهم لعياله) ومن هذا الينبوع الغزير (المحبة) تفيض ألوان من التراحم والتعاطف وتسلسل نسيمات وجدانية يجد المؤمنون جوارها برد السلامة والعافية.
والإمام الكاظم عليه السلام: أمر أصحابه بالتوادد والتآلف وزيارة بعضهم بعضاً لأنها توجب شيوع المودة بينهم، مضافاً لما لها من الأجر العظيم عند الله. قال عليه السلام: (من زار أخاه المؤمن لله لا لغيره يطلب به ثواب الله، وكّل الله به سبعين ألف ملك من حين يخرج من منزله حتى يعود إليه ينادونه: ألا طبت وطابت لك الجنة، تبوأت من الجنة منزلاً..).
وفي حديث لرسول الله صلّى الله عليه وآله: (إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يتغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، بمكانهم من الله تعالى قالوا: يا رسول الله تحيرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا اموالٍ يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وأنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ﴿أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.
وروى الكليني بإسناده عن محمد بن سليمان، عن محمد بن محفوظ قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (ليس شيء أنكى لإبليس وجنوده من زيارة الإخوان في الله بعضهم لبعض، قال: وإن المؤمنين يلتقيان فيذكران الله ثم يذكران فضلنا أهل البيت فلا يبقى على وجه إبليس مضغة لحم إلا تخدّد حتى أن روحه لتستغيث من شدة ما يجد من الألم فتحس ملائكة السماء وخزان الجنان فيلعنونه حتى لا يبقى ملك مقرب إلا لعنه، فيقع خاسئاً حسيراً مدحوراً).
السخاء وحسن الخلق
لقد حثّ القرآن الكريم على حسن الخلق ورغب فيه ودعا إليه بأسلوب هو غاية في الروعة والأداء، فيه التشوق إلى العطاء الذي ما بعده من عطاء. ألا وهو قرض الله قرضاً حسناً وهل هناك أكرم وأعظم من هذا الذي نقرضه؟ إنه العلي القدير، الرحمان الرحيم رب العالمين فاطر السماوات والأرض صاحب العرش العظيم. قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.
فأي تلطف من رب العالمين تبارك وتعالى في هذا التعبير الذي يجعل الإحسان بمثابة الأقراض وإنما يقترض المحتاج والله غني عن العالمين حيث له ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولقد جاء التعبير بمثل هذه الصورة نيابة عن الفقراء والمحتاجين ودفاعاً عنهم. وما قيمة امرئ يبخل بأقراض بعض المال لواهبه الذي سيرده بلا ريب أضعافاً مضاعفة!! والإمام الكاظم عليه السلام لهذا كله حث أصحابه على التحلي بالسخاء وحسن الخلق قال عليه السلام: (السخي الحسن الخلق في كنف الله، لا يتخلى الله عنه، حتى يدخله الجنة، وما بعث الله نبياً إلا سخياً، وما زال أبي يوصيني بالسخاء وحسن الخلق..).
وقد عمل عليه السلام بوصية أبيه عليه السلام ثم بوصية جده صلّى الله عليه وآله الرسول الأكرم الذي قال: (ألا أخبركم بأحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون…).
مكارم الأخلاق
سأل رجل رسول الله صلّى الله عليه وآله عن حسن الخلق، فتلا قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ثم قال صلّى الله عليه وآله: (وهو أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك).
وقال صلّى الله عليه وآله: (إن الخلق الحسن ليميت الخطيئة كما تميث الشمس الجليد).
وجاء في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً).
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: (ما يتقدم المؤمن على الله عزّ وجلّ بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من أن يسع الناس خلقه).
والإمام الكاظم عليه السلام عني بهذه الظاهرة فكان دوماً يوصي أصحابه بالتحلي بالصفات الكريمة ليكونوا بسلوكهم وهديهم قدوة صالحة لهم وللمجتمع، حتى يستطيعوا على نشر مفاهيم الخير والصلاح بين الناس.
وفي معنى الخلق وكيفيته وتهذيبه: قال العلماء: ليس الخلق عبارة عن الفعل، فرب شخص خلقه السخاء، ولا يبذل إما لفقد المال أو لمانع آخر. وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعث أو رياء. ولا عبارة عن القدرة لأن نسبة القدرة إلى الضدين واحدة. ولا عن المعرفة فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعاً على وجه واحد بل هو عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة.
وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاً لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم والخد بل لابدّ من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر، فكذلك لابدّ من الباطن من أربعة لابدّ من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق وهي: قوة العلم، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث:
۱- قوة العلم: فحسنها وصلاحها من أن تصبر بحيث يسهل لها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين الجميل والقبيح في الأفعال، فإذا تحصلت هذه القوى حصل منها ثمرة الحكمة التي هي رأس الأخلاق الحسنة (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً).
۲- قوة الغضب: وأما قوة الغضب والشهوة فحسنهما في أن يقتصر انقباضهما وانبساطهما على حدما تقتضيه الحكمة والدين.
۳- قوة العدل: وأما قوة العدل فهي ضبط قوة الغضب والشهوة تحت إشارة العقل والشرع، فالعقل منزلته منزلة الناصح والمشير، وقوته القدرة ومنزلتها منزلة المنفذ الممضي لإشارته، والغضب والشهوة تنفذ فيهما الإشارة.
ومثال الغضب مثال كلب الصيد، فإنه يحتاج إلى أن يؤدّب حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب الإشارة لا بحسب هيجان النفس. ومثال الشهوة مثال الفرس الذي يركب في طلب الصيد، فإنّها تارة تكون مروضاً مؤدباً، وتارة تكون جموحاً، فمن استولت فيه هذه الصفات واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاً، ومن اعتدل فيه بعضها دون بعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة، كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون البعض.
وحسن قوة الغضب واعتدالها يعبر عنه بالشجاعة، وحسن قوة الشهوة واعتدالها يعبر عنه بالعفّة، فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال سمّي ذلك تهوراً، وإن مالت إلى الضعف والنقصان سمّي ذلك جبناً وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف الزيادة سمي شرهاً وإن مالت إلى النقصان سمي خموداً. والمحمود هو الوسط، وهو العدل والفضيلة، والطرفان رذيلتان مذمومتان والعدل إذاً فات فليس له طرفان بزيادة ونقصان، بل له ضد واحد وهو الجور.
وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال في الأغراض الفاسدة خباً، ويسمي تفريطها بلهاً، والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة والخلاصة أن أمهات الأخلاق الحسنة والجميلة وأصولها أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل.
لم يبلغ كمال الاعتدال من البشر في هذه الأصول الأربعة إلا رسول الله صلّى الله عليه وآله ولهذا أثنى الله عليه قائلاً: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.
والناس بعدة يتفاوتون في القرب والبعد فينبغي أن يقتدي به. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُــــوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجـــَاهَدُوا بِأَمْوَالِهــــِمْ وَأَنْفُسِهــــِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾.
فالايمان بالله ورسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين، وهو ثمرة العقل، ومنتهى الحكمة.
والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة، والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال. وقد وصف الله عزّ وجلّ به قوماً فقال: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.
وهذه إشارة إلى أن للشدة موضعاً وللرحمة موضعاً، وليس الكمال بالشدة في كل حال، ولا في الرحمة بكل حال.
وما نراه اليوم يتمثل عملياً على ارض لبنان في الجنوب الحبيب والبقاع الغربي الحبيب على يد أبطال المقاومة المسلمة الذين استعملوا الشدة في موضعها فجاهدوا بأنفسهم بكل شجاعة محكمين غضبهم على شرط العقل، ومقاومين عناقيد الغضب بدمائهم الزكية الطاهرة فإيمانهم في غير ارتياب لقوة يقينهم وهم بالنتيجة الصادقون الصابرون.